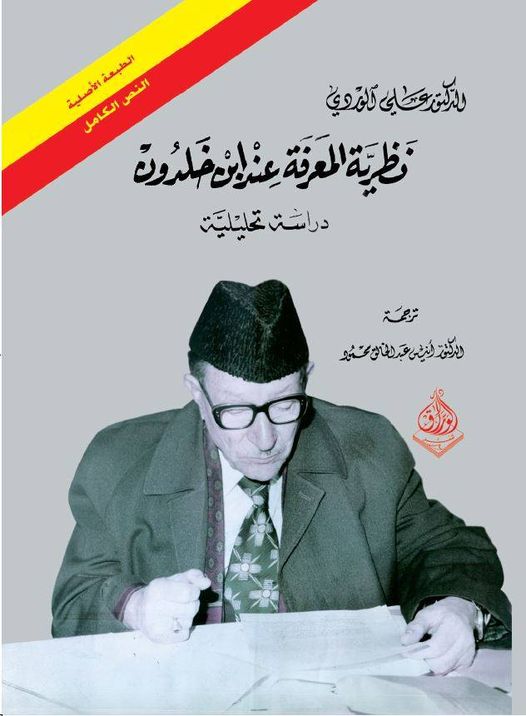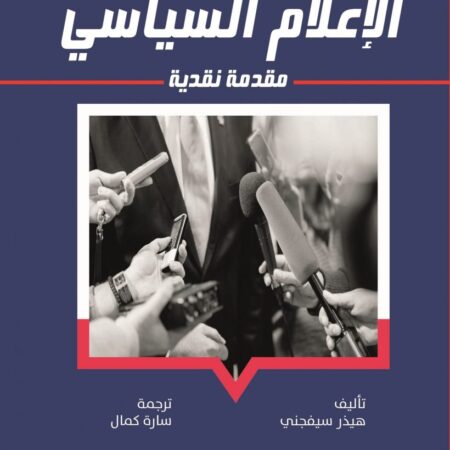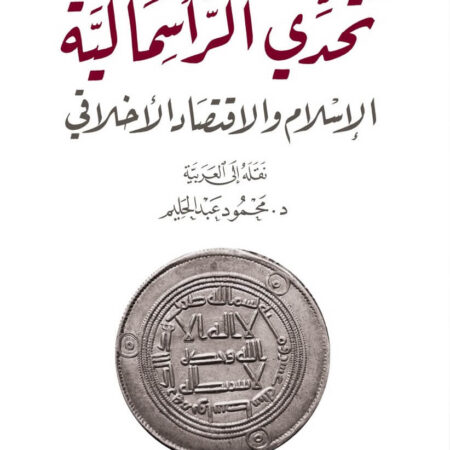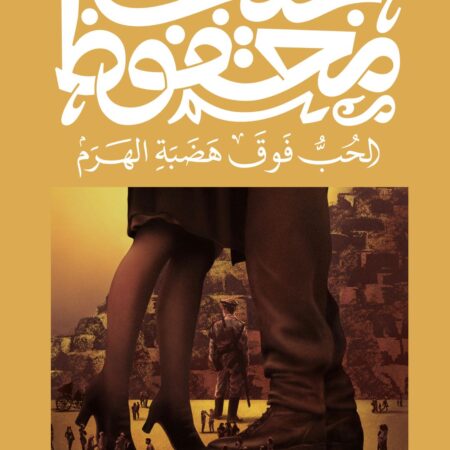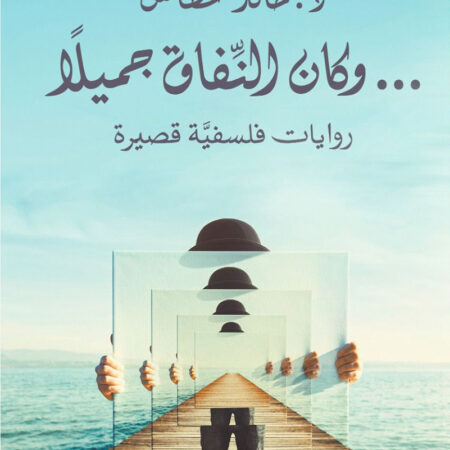الوصف
نظرية المعرفة عند ابن خلدون -دراسة تحليلة – يعدّ ابنُ خلدون من المفكّرين المسلمين العِظام خلال القرن الرابع عشر (1332-1406م). ويميل الكُتّاب المعاصرون إلى عَدّه رائدًا وسبّاقًا في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، ويعدّه بعضُهُم أوّل عالِمِ اجتماعٍ في تاريخ البشريّة، بل وحتّى مؤسّس علم الاجتماع الحديث. ويُعِدُّ أحد الثقاة مقدّمته، التي هي الموضوع الأساس للدراسة في الكتاب الحاليّ، أحد ستة مؤلّفات متخصّصة في علم الاجتماع العامّ.
ليس الهدف من هذه الأطروحة دراسة ابن خلدون أو نظريّته بالتفاصيل الدقيقة؛ فقد أنجز باحثون معاصرون آخرون هذه المهمّة بنجاح، بل هدفها مختلفٌ، وهو أن ننظر إلى ابن خلدون من زاوية مختلفة، أو على حدّ تعبير كارل مانهايم(*)، من منظور يختلف عن المفهوم المألوف تمامًا. فقد عاش ابن خلدون في ثقافة تختلف تمام الاختلاف عن ثقافتنا الحاليّة، وكان ينظر إلى العالم ضمن إطار مرجعيّ ربّما غير مألوف لنا تمامًا. ولذلك، فمهمّتنا الأولى ـ لكي نفهم ابن خلدون ـ هي إعادة بناء وجهة نظره أو إطاره المرجعيّ من جديد، ونحاول أن ننظر إلى الظواهر الاجتماعيّة من خلاله.
والمجال المخصّص لمناقشة نظريّة ابن خلدون بحدّ ذاته صغيرٌ في هذا الكتاب مقارنةً بما هو مخصّصٌ لإعادة بناء المنظور والفئات الفكريّة التي نظر ابن خلدون وأتباعُهُ الكُتّاب إلى العالم من خلالها. ولأن هذا الكتاب، كما يبيّن عنوانُهُ الجانبيُّ، هو غالبًا ما تكون لا واعية ولا يمكن الخلاص منها تقريبًا. ولذلك، فالموضوعيّةُ الكاملة في التفكير مختلفةٌ تمامًا إن لم تكن مستحيلة.
ومع ذلك، يمكن أن نحصل على مستوى جديد من الموضوعيّة، كما يشير مانهايم:
في حالة التفكير المتكيّف موقعيًّا، تعني الموضوعيّة شيئًا جديدًا ومختلفًا تمامًا: (أ) قبل كلّ شيء، بقدر ما يغوص المراقبون المختلفون في منظومة واحدة، فسيصلون إلى نتائج متشابهة ويصبحوا في وضع يُمَكِّنهم من القضاء على كلّ ما يراه هذا الإجماع خطأً على أساس هويّة أدواتهم المفاهيميّة والفئويّة ومن خلال العالَم المشترك للخطاب الذي نشأوا عليه؛ (ب) وفي الآونة الأخيرة برز ادراكٌ مفاده أن الموضوعيّة لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بطريقة ملتوية لأن رؤى المراقبين مختلفةٌ. وفي هذه الحالة، فلابدّ أن نفهم ما أصاب المنظوران في إدراكه ـ ولو بطريقة مختلفة ـ من زاوية الاختلافات في بِنية أنماط التصوّر المختلفة تلك. ولابدّ أن نجد صيغةً لترجمة نتائج أحدهما إلى نتائج الآخر ونكتشف قاسمًا مشتركًا لتلك الرؤى المختلفة. وحالما نعثر على هذا القاسم المشترك، يصبح بالإمكان فصل الاختلافات الضروريّة لهاتين النظرتين عن العناصر التي فُهمت على أنها تعسّفيةٌ وخاطئٌة، والتي لابدّ أن نعدّها هنا على أنها أخطاء أيضًا.
وبعد أن نأخذ هذا النوع من الموضوعيّة قياسًا لنا، نبدأ بدراسة ابن خلدون الذي كان هو نفسه ـ وفقًا للأحكام القديمة للموضوعيّة ـ متحيّزًا بالكامل؛ إذ نستطيع أن نميّز في كتاباته التأثير القويّ لوضعه الطبقيّ ومواقفه الشخصيّة في تفكيره. وعلى وفق مبدأ الموضوعيّة المطلقة، سنضطرّ إلى أن نجرّد نظريّته من أيّ قيمة علميّة، رغم أنه قدّم، كما يقول هوارد بيكر(*) ”أغرب نظريّة حديثة يمكن أن يتخيّلها إنسان.
يبدو أن تحيُّز ابن خلدون القويّ كان أحد أهمّ عوامل ابداعه العلميّ؛ فمن خلال هذا التحيُّز استطاع أن يرى ما لم يستطع الآخرون رؤيته. وسنلاحظ فيما بعد أن معاصريه كانوا مكبّلين عندما درسوا الظواهر الاجتماعيّة بتصوّراتهم ”المثاليّة“ وأحكام تفكيرهم الطبقيّة، في حين عَبَر ابن خلدون تلك القيود بسبب وضعه الطبقيّ المتميّز وسيرته السياسيّة العاصفة إلى الجانب الآخر من التلّ الذي استطاع أن يؤسس فيه رأيًا خاصًّا به.
ولذلك، فإن خطّة الدراسة الحاليّة تدعو إلى شنّ هجوم غير مباشر إلى حدٍّ ما على نظريّات ابن خلدون الاجتماعيّة. وسنخصّص جزءًا كبيرًا من النقاش لدراسة الآراء المتناقضة ومنظومات القِيَم التي ميّزت زمانه ومكانه؛ فقد وجدنا أن نظريّته لا يُمكن أن تُفهم فهمًا كاملاً دون أن نقوم بذلك. ومن خلال مناقشة شاملة لأهمّ معالم الآيديولوجيّات المختلفة وأساليب التفكير التي سبقت ظهور كتاب ابن خلدون، سنتمكّن من تسليط المزيد من الضوء على نظريّاته.